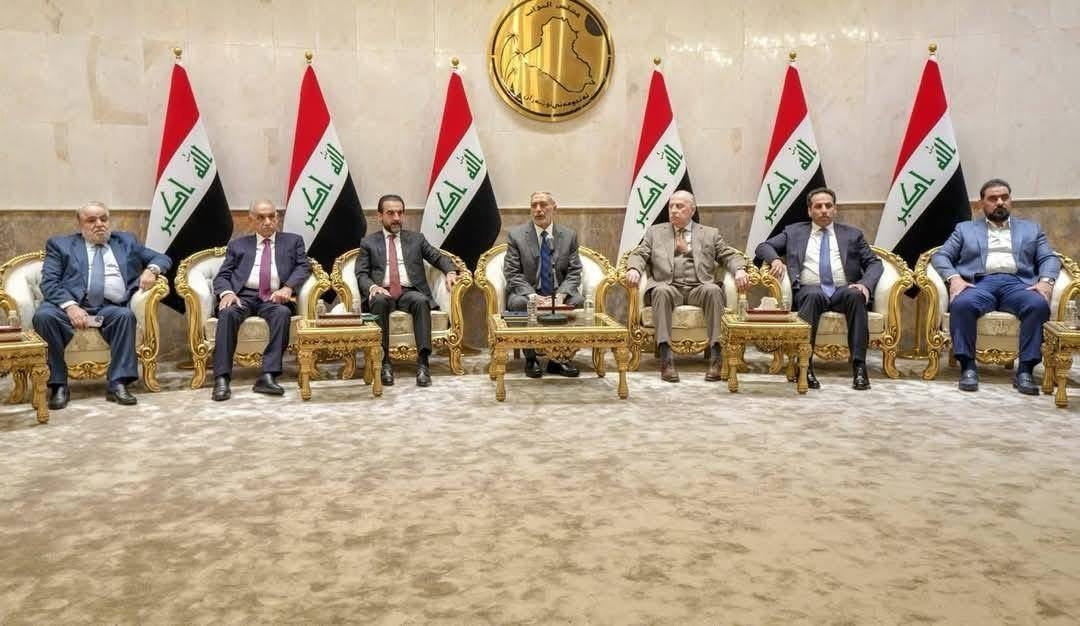"ترمبية" عنصرية فوضوية قبل ترمب ومعه وبعده
- 13-01-2021, 14:55
- 1217
يبدو الرئيس دونالد ترمب مصرّاً على أنه لن يخرج من البيت الأبيض إلا مطروداً. والأميركيون مضطرون للتطلع في ثلاثة اتجاهات، بدل التركيز كالعادة وقت تغيير الرئاسة على برنامج الرئيس الجديد.
الاتجاه الأول القريب الذي فرضته صدمة اقتحام الكونغرس بتحريض من ساكن البيت الأبيض الخاسر هو ما يجب فعله لكف يد ترمب عن إلحاق المزيد من الأذى بأميركا والديمقراطية والدستور والاندفاع في مغامرة حمقاء في الخارج.
الاتجاه الثاني هو الأساس التقليدي المهم: القراءات في مشاريع الرئيس جو بايدن ونوعية الذين اختارهم كأركان إدارته، وتقديم الأفكار والاقتراحات لإجراء التغيير المطلوب. والاتجاه الثالث الذي لم يسبق البحث فيه عندما يغادر الرؤساء البيت الأبيض هو ما سيفعله ترمب وأنصاره على المستوى السياسي والتحرك في الشارع وما ينتظره من دعاوى تجارية وجزائية.
والسؤال الذي يشغل كثيرين هو: هل انتهى الضرر الذي أحدثه ترمب، وكانت قمته "غزوة "الكونغرس، أم أن الرجل لا يزال عازماً وقادراً على فعل المزيد وإثارة المتاعب لبايدن وتنغيص عيشه السياسي؟ وإلى أي حد يمكن الاطمئنان إلى كون الديمقراطية الأميركية قوية وقادرة في النهاية على حماية نفسها، لا فقط من الغوغاء بل أيضاً من نزعات انقلابية لدى أعضاء في الكونغرس يؤمنون بنظرية "المؤامرة" ويمارسون الصغائر ويستعدون لارتكاب الكبائر؟
الانطباع الشائع أن المعادلة هي: ترمب خارج السلطة، و"الترمبية" تملأ الشارع. ولا شيء يضبط الترمبية. لا هي أيديولوجيا مثل النازية والفاشية والشيوعية. ولا هي حركة يقودها حزب يقوده زعيم ومكتب سياسي وله برنامج سياسي.
إنها مجموعات متنوعة برؤوس متعددة، بلا نظرية ولا فكر ولا ثقافة. ميليشيات بينها "ميليشيا الحرية" في ميشيغان و"أولاد فخورون" و"حافظو القسم". ورجال غاضبون ونازيون جدد وعنصريون.
وما يجمع هؤلاء هو التطرف اليميني والخوف من تكاثر الملوّنين في أميركا والادعاء أن نخبة المدن الساحلية "سرقت" منهم الدولة وأفقدتهم فرص العمل التي نقلتها الشركات الكبيرة إلى بلدان العمالة الرخيصة.
ترمب الذي يدّعي أن الديمقراطيين "سرقوا" منه الانتخابات ليس صانع هذه الحركة، ولا سبب وجودها بل هو نتيجة لها. هو رجل الأعمال الذي عرف كيف يلعب على أحلام الفقراء ويقنعهم أنه "بطلهم". والألعبان الكاذب الذي ركب موجة الغضب لدى المهمشين في الأرياف وأيتام الكونفيدرالية في الجنوب.
وبكلام آخر، فان جذور الترمبية كانت موجودة قبل ترمب، وكبرت معه، وباقية بعده، سواء صار خارج الشاشة أو استمر يعمل تحت الأضواء وعاد إلى التنافس على الرئاسة عام.
وهو ظاهرة عابرة على سطح مشكلة ثابتة تضغط على ملايين الأميركيين. وليس من السهل "احتواء" هذه الحركة من دون إجراءات واسعة وملموسة. حتى قبل الاعتداء على الكونغرس، فإن استاذتَيْ العلوم السياسية سوزان هايد وإليزابيت ساوندرز أكدتا "أن الضرر كبير وما فعله ترمب ليس وراءنا". وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال "لا نريد العودة إلى الوضع الطبيعي قبل ترمب، وإذا لم نقم بتغيير جريء فننتهي أسوأ من ترمب".
وهناك من يرى حاجة إلى عقود لإصلاح ما أحدثه ترمب من خراب خلال أربع سنوات. وليس واضحاً ما إذا كان بايدن سيفتح الباب أمام ما دعاه إليه جيمس فولوز في "أتلانتيك" من فتح ملفات ترمب ومحاكمته. لكن الواضح أن ترمب ليس راغباً في الذهاب إلى التقاعد وكتابة المذكرات وتأسيس مكتبة باسمه كما فعل أسلافه من الرؤساء، وآخرهم باراك اوباما الذي أصدر الجزء الأول من مذكراته تحت عنوان "أرض موعودة".
أوباما يروي أنه قرأ شكسبير، مارتن لوثر كينغ، رينهولد راينر، ماركس، شتاينبك، والت وايتمان، توني موريسون، همنغواي، فوكنر، فيليب روث، ألكسيس دو توكفيل وسواهم. ترمب لا يقرأ حتى التقارير. هو مدمن "تغريد" لمهاجمة خصومه وأصدقائه. ويكتفي بالتلفزيون وسماع الأخبار التي قال أوباما إنها "تشعرنا أحياناً أننا نرى من برج بابل، ولا نستطيع سماع أصوات القريبين منا".
لكن قلة الثقافة هي رأسمال الترمبية التي تبدو "داعشية" على الطريقة الأميركية. وتلك هي المسألة والمشكلة.